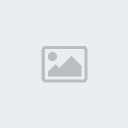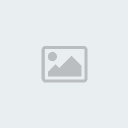الغير
•التقديم
•وجود الغير و معرفته
•العلاقة مع الغير
التقـديــم
غالبا ما نقول لسنا وحدنا في هذا العالم" لكن هذا القول قد تترتب عنه نتائج
بعيدة المدى حينما يتم التفكير فيه فلسفيا، فإنه يعتبر حقيقة أولية و بذلك
سيطرح تساؤلا حول مصير الكوجيطو الديكارتي "أنا أفكر إذن أنا موجود"، و
إذا افترضنا صحة هذا القول "لسنا وحدنا في هذا العالم" ألن يتحول الكوجيطو
إلى حقيقة ثانية و بالتالي لن يصبح بديهيا بل مجرد عمل فكري بناء، و لكنه
ذو طبيعة شكلية، إننا بالفعل لسنا وحيدين في هذا العالم و لن نكون كذلك
أبدا حتى في جزيرة مقفرة بل سنكون على علاقة دائمة بالآخرين لأنهم سيشغلون
حيزا من تفكيرنا و يعطون معنى لأفعالنا، إذ ما يمكن أن يترتب عن القول: أنا
أفكر إذن أنا موجود إن لم يكن مجرد تجربة فردية و ميتافيزيقية بالمعنى
الدقيق، أو تجربة ذات بعد تخيلي إلى حدود ما يمكن أن يتصوره الفكر، إلا أن
حضور الغير كموضوع للتفكير و كمشكلة فلسفية لم يظهر إلا في فترة زمنية
متأخرة بالنسبة للفلسفة و بالتحديـد في فلسفة هيكـل، فما كان يشكل و يشغل
مجال التفكير البشري و المعرفة الموضوعية التي يتواجه فيها الطرفان من جهة
الذات العارفة و من جهة أخرى موضوع المعرفة. و على هذا الأساس ما كان موضوع
اهتمام أولي هو البحث عن الأسس التي تقوم عليها الحقيقة و العلوم في شكل
مواجهة بين الوعي الذاتي المتمثل في أنا أفكر و بين الواقع الخارجي كموضوع
وحيد.
إن هذه المواجهة الجذرية بين الإنسان و العالم تستبعد أي تدخل أو حضور لطرف
ثالث باستثناء الله، الذي يستدعيه ديكارت ليضمن الحقيقة في مجال العلوم و
التي تم التوصل إليها عن طريق المنهج العقلي و هكذا فالمعرفة العلمية
الموضوعية لا ينبغي أن يتـدخل فيها طـرف ثـالث: لا المجتمع و لا التاريخ و
لا الرغبات بل و لا حتى الغي.
وجود الغير و معرفته فعليا و موضوعيا فإن الغير لا يوجد في حد ذاته، ففي
العالم الموضوعي للمعرفة العقلية فإن الموجودات البشرية الأخرى، ليست إلا
شيئا من ضمن أشياء العالم الخارجي، و يمكن أن تضاف ماديا إما إلى الحيوانات
الآلات أو إلى كائنات أوتوماتيكية و من حجم أو قامة معينة، و لها وزن محدد
بمعنى أنه يتحرك بطريقة عشوائية في مكان محدود، أما من الناحية العلمية
فإن الغير ليس إلا من أشياء العالم الخارجي، لكنه شيء تبدو تصرفاته ظاهريا
جد معقدة و أقل انضباطا و توقعا مما يمكن أن يكون منحنى حجر أو مجرى نهر أو
مدار كوكب، يقول ديكارت: "لو نظرنا إلى الناس من نافذة في شرفة البيت و هم
يتحركون في الشارع فماذا سنرى أكثر من المعاطف و القبعات التي تكسو أشباحا
أو أناسا باهتين يتحركون بواسطة لوالب" التأملات التالية:
هكذا و في منتهى التحدي لما يمكن أن يحول بين معرفة الحقيقة فإن ديكارت
يستبعد من مجال تأملاته حضور الغير، و بذلك انتهى إلى القول: [ كل ما أنا
متأكد منه أني وحدي موجود ] يبقى إذن أن وجود الآخر أمر جائز محتمل لكنه
قابل للشك.
إن دخول الغير إلى مجال الإدراك أو المعرفة سيقلب الأمور رأسا على عقب و
سيفرض عليه فقط إعادة النظر كليا في مسألة المعرفة بل في كل القضايا
المتعلقة بالموضوعية و العلم و وعي الذات بطبيعتها.
و هكذا نجد أن طوماس هوبس في مقطع مثير للجل يعتبر أن الإنسان ذئب لأخيه
الإنسان، إلا أن روسو سيرد عليه بأن الإنسان خير بطبعه، أما كارل ماركس
فسيعتبر [ أن الصراع الطبقي هو المحرك للتاريخ البشري ] في حين سيؤسس كونط
تحت اسم السوسيولوجيا ديانة للبشرية يشكـل شعار [ العيش من أجر الغير ] أحد
تمثلاتها.
إن كونط يظهر هنا كوريث لأرسطو الذي اعتبر الإنسان حيوان سياسي ينتج عن ذلك
أن علاقة الفرد مع بقية الكائنات البشرية الأخرى ليست ذات طابع هدفوي لكها
علاقة بناءة، هكذا يبدو أن العلاقة مع الغير هي علاقة مؤسسة و تكتسي طابعا
مصيريا، ذلك أنها تقوم على أسس معينة و لكنها أيضا لا تكف عن التغير، و
يمكن أن تتخذ أشكالا أكثر تنوعا إن لم تكن أكثر تناقضا بل هي الشكل الأرقى
المعبر عن طبيعة الوضعية الإنسانية.
ضد الموقف الديكارتي الذي يؤكد على الوجود الذاتي الخاص سيقدم هيجل العلاقة
مع الغير في إطار جذري حينما قدم أطروحته "صراع الوعي حتى الموت من أجل
الاعتراف"، لقد اعتبر هيجل أن الإنسان يكون واعيا بذاته و بذلك ينغمس في
إشباع رغيته الطبيعية و لا يخرج من هذه المرحلة إلا حينما يرغب رغبة غير
طبيعية و هي ما يسميها هيجل برغبة الرغبات.
يقول هيجل: "إن الفرد الذي لم يغامر بحياته يمكن أن يعترف به كشخص، و لكنه
لن يدرك أبدا حقيقة هذا الاعتراف، كاعتراف بوعي الذات بذاتها المستقلة". إن
الاعتراف يقتضي بالضرورة الدخول في صراع مع الغير، إنه صراع يغامر فيه كل
طرف بحياته بطابعها الحر و المستقر، إنها مغامرة يخاطر فيها الطرفان معا
بحياتهما من أجل الحياة و الموت، لكن الموت الفعلي لأحد الطرفين لن يحقق
هذا، بل يحقق تفضيل أحدهما للحياة على الموت و بذلك يتجلى ارتباط الطرف
المستسلم بالعالم المادي المحسوس فتتشكل العلاقة الإنسانية الأولى ألا و هي
[ علاقة العبد بسيده ].
و في نفس الاتجاه يؤكد جون بول سارتر أن العلاقة مع الغير تتخذ بعـدا
وجوديا و معـرفيا، و بهذا المعنى يقول إن الآخر شرط لوجودي كما لا غنى لي
عنه في معرفتي بنفسي (انظر درس الشخصية).
إن هذا البعد المعرفي يطرح إشكالية أساسية ألا و هي: هل يمكن أن يكون الغير
موضوعا للمعرفة، ألا تتحول العلاقة المعرفية إلى علاقة بين ذات عارفة و
موضوع للمعرفة.
إذا كانت عملية المعرفة فعل يتم من خلاله إدراك موضوع المعرفة فهل ينطبق مفهوم الموضوع على الغير.
إن افتراض قابلية الغير للمعرفة ينتج عنه بالضرورة تحويله إلى موضوع و بذلك
نجرده من معاني الذات التي أكد عليها الخطاب الفلسفي المتمثلة في الوعي و
الإرادة و الحرية و التلقائية و بذلك يفقد الغير مقوماته بل إن هذه العلاقة
المعرفية تحمل نوعا من التناقض و الاستحالة، و تخلق هوة سحيقة و عد ما
يستحيل معه كل تواصل بينهما على قدم المساواة، لأن العلاقة المعرفية هي
علاقة تشييئية لكل منهما لأنها قائمة على العلاقة المعرفية الخارجية، غيـر
أن هـذه العـلاقة الموضوعية و التشييئية للغير تنطلق من موقع الأنا المفكر
أو العقـل و نشاطهما القـائم على التجـريد و التقسيم و الحكم و الاستدلال، و
يمكن تجاوز هذه العلاقة في نظر ميرلو بونتي عندما يدخل الأنا و الغير في
علاقة الاعتراف المتبادل بكل منهما في فرديته و وعيه و حريته، لكن علاقة
الغير بالأنا تظل خارجية و تقيم حاجزا بينهما حتى حينما يدخلان في علاقة
عاطفية وجدانية فمهما أشارك الآخر "صديقي" مثلا حزنه أو غضبه فإني أبدا لا
أستطيع أن أتجاوز الحزن لحزنه و الغضب لنفسه، و لكني لا أعيش أبدا نفس
الحالة العاطفية الوجدانية التي يعيشها هو.
إن علاقة الأنا بالغير تظل خارجية و لهذا تبدو معرفته في جوهره أمرا
مستحيلا لكن هذا النفوذ إلى باطن الغير ضروري لاستجلاء أسراره، أليس الأنا
الآخر شبيها بالأنا و مماثل له في طبيعته و جوهره، ألا يكفي أن يستبطن
الأنا ذاته و يقيس أفعال الغير و سلوكاته و تعابيره على ما هو مماثل
بالنسبة له، فإذا دلت الابتسامة عندي على الفرح فلماذا لا تدل على هذه
المشاعر عند الغير، غير أن الافتراض القائم على إمكانية معرفة الغير عن
طريق الاستدلال بالمماثلة ينطوي على مفارقة جوهرية ألا و هي: عندما أشاهد
حركات التعبير الصادرة عني فأنا ألتقي من جديد بذاتي "أنا" و ليس بأنا
الغير، و لذلك فحينما ينتهي حكم المماثلة إلى إثبات أنا مختلف عن أناي فإنه
يقرر نتيجة خاطئة ثم إن المعرفة القائمة على المماثلة و التي تتخذ الأنا
كمرجع لمعرفة الغير ليست يسيرة خصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار مفهوم
اللاشعور كما أسسه التحليل النفسي فنحن نحمل في أعماقنا حياة نفسية
لاشعورية لا يصلها وعينا و يكون الغير المحلل النفسي وسيطا ضروريا لبلوغها.
و يطرح شيلر إمكانية تجاوز كل هذه الصعوبات إذا تجاوزنا خلفياتها الفلسفية
القائمة على ثنائيات متعددة: جسم و نفس، ذات و موضوع، ظاهر و باطن، و
اعتبرنا الغير كلا موحدا لا يقبل التجزئ و التقسيم و اعتبرنا حقيقة و هوية
مجسدتان فيه كما يظهر الأنا، و حركات التعبير الجسدي لديه، حاملة لمعناها و
دلالتها مباشرة كما تظهر، و في سياق تجاوز هذه الثنائيات قدم "جيل دولوز"
تصوره للغير كبنية، بمعنى أن الغيـر ليس فردا مشخصا، بـل هو عبـارة عن
نظـام من العـلاقات و التفاعلات بين الأشخاص و الأفراد كأغيار، يتجلى هذا
النظام في الإدراك الحسي مثلا، فنحن لا ندرك الأشياء المحيطة بنا حينما
ندركها من جميع جهاتها و جوانبها باستمرار، و هذا يفترض أن هناك آخرين
يدركون ما لا أدركه من الأشياء، و إلا بدت الأشياء و كأنها تنعـدم حينما لا
أدركها و تعود إلى الوجود حين إدراكي لها، و هذا يعني أن الغير يشاركني
إدراكي، و كأنه يوجد على هامش إدراكي كمجال ممكن، إن هـذا الممكـن الإدراكي
يكون تخييليا حينما يغيب الآخـرون عن إدراكي و يكون فعليا في حضورهم،
فالوجه المفزع أو المخيف عن ممكن حاضر فعلا، و لكنه قد يكون تخيليا في غياب
الحضور الفعلي إلا أنه لا يكون له نفس الأثر هذا التداخل بين الممكن
التخيلي و الحضور الفعلي هو ما يجعل من العلاقة مع الغير ذات طـابع بنيوي
معقد و هو الـذي ي***** معنى للأشيـاء و العالم مهما اختلفت علاقة الأنا
بالغير.
هكذا يبدو أن العلاقة مع الغير لا يمكن اختزالها إلى مجرد علاقة معرفية،
إنها أغنى و أعقد من ذلك، فهي في الواقع الفعلي علاقة مركبة عاطفية
وجدانية، أخلاقية اقتصـادية، سيـاسية ثقـافية و اجتماعية، كما أنها تختلف و
تتنوع تبعا لأوجه العلاقة مع الغير، كما يتجلى ذلك في الكلمات التي تؤرخ
لسجل العلاقة مع الغير: الحب و الكراهية، الصداقة و العداوة، الإيثـار و
الأنـانية، التعصـب و التسامح.
أوجه العلاقة مع الغير
إذا عدنا إلى الوصف الهيكلي للصراع حتى الموت من أجل الاعتراف فإنه لا يقدم
صورة واقعية عن طبيعة العلاقة بين الذوات الواعية، و لا يأخذ في الاعتبار
تعـدد أوجه العـلاقة مع الغيـر و التي تتخذ أبعادا متعددة، بين الابن و
أبيه و الأم و ابنها، و عشيقيـن متيميـن، بيـن خصم و منافسه، بين معلم و
مريديه، بين صديقين و أخيرا بين الضحية و الجلاد.
هذه العلاقات تتأسس لكنها لا تكف أن تتغير و يمكن أن تتخذ أشكالا أكثر
تنوعا إن لم تكن أكثر تناقضا، إنها الشكل الأكثر تعبيرا عن طبيعة الوضعية
الإنسانية، فأوجه العلاقة مع الغير تم طرحها بصيغ مختلفة، يمكن إجمالها في
الصيغ التالية [ الإنسان ذئب لأخيه الإنسان ]، [ الإنسان إله لأخيه الإنسان
] سبينوزا، أو كما قال سارتر "الآخرون هم الجحيم"، [ إن أكبر عقاب لي هو
أن أكون وحدي في الجنة ] مال برانش.
إن هذه الصيغ يمكن أن تجد مبرراتها بشكل من الأشكال، لكن الخطأ يكمن في دحض
بعضها لصالح البعض الآخر بمعنى اعتبار جميع الناس من طبيعة واحدة و
بالتالي اعتبار جميع الناس إما أشرارا أو أخيارا بينما هم في الواقع يقيمون
فيما بينهم أشكالا متعددة من العلاقات، و قد حاول فرويد أن يجمل أوجه
العلاقات مع الغير في 4 أنواع: [ إن الغير يلعب دائما في حياة الفرد دور
القدوة أو المثل أو الشيء، أو المشارك أو الخصم ]، و لكن ينبغي أن نضيف أن
هذه الأدوار لا تتحدد بشكل مطلق بل إنها تتغير بشكل جدلي، كما يبين ذلك
سارتر.
إن كلا منا أو أيا منا، ممثلا كان أو رجل دولة أو إنسانا من عامة الناس
يتمظهر في أوجه مختلفة و يستعمل الكثير من اللغات و يتصرف بطريقة خاصة
حينما يفرض عليه ذلك مخاطبوه في ظروف محددة، إن الغير يكشف لنا عن غنى و
تعقيد مشاعرنا الخاصة، هذه المشاعر التي تمتد من الأنانية المفرطة إلى
الإيثار الاجتماعي، و هكذا فالغير ليس ذلك الوجه الآخر الذي نجده أمامنا
وجها لوجه أو هو على مقربة منا، إنه أيضا ذلك الذي نجرده من ذواتنا و الذي
يمكننا في التفكير في "نحن" قبل أن نفكر في الأنا، إننا نتمظهر إلى "النحن"
الجماعي بشكل يتجاوز الأنا بصيغة المفرد النحوي كما لو كنا نجمع في ذواتنا
مجموعة من الذوات الأخرى المغايرة تبعا لتغير الآخرين الذين نوجه إليهم
الخطاب ذلك أن وحدتنا النفسية ليست معطاة بشكـل جاهـز و فوري، إنها في آخـر
المطاف ناتجة و ناشئة عن اختيار صعب من بين مجموع الكائنات و الذوات التي
نحملها في داخلنا، بينما يميل البعض إلى الحكم الموضوعي فإن البعض الآخر
مدعو إلى التحكم بالشكل الذي يمكن من تكوين ذاتنا كموضوع، و هكذا يبدو أن
الإشكالية الفعلية في الضمائر ليست في أنا أو أنت أو هم، بل الضمير الجمعي
في صيغة نحن، ذلك أنه حينما نقول نحن، سواء تعلق الأمر بالمجتمع الذي يشكله
مع الغيـر، و ذالك الذي يشكله مع ذاتنا فإننا نضع موضع تساؤل الوحدة
الاجتماعية التي تشكل كينونتنا فتارة نعني بهذا تعدد فرديتنا أو ذاتنا و
تارة أخرى نقصد أنا و أنت و في أحيان أخرى كل من ينتمي إلى مجموعتنا أو
ح*****نا أو عرقنا، كما أنها قد تعني بشكل عام الوضعية الإنسانية ككل.
إن العلاقة بين الأنا و الآخر تكتسي طابعا متعدد الأوجه، كما أنها تختلف و
تتنوع تبعا لتعدد أوجه الغير، و ذلك ما يعكسه الخطاب المتبادل بين الأنا و
الغير، و من جهة أخرى تنعكس هذه العلاقة في الكلمات التي تدخل في سجل
العلاقة بين الغير: الحب و الكراهية، الصداقة و العـداوة، الإيثـار و
الأنانية، التعصب و التسامح، إن هذه الثنائيات تحيل إلى وجهين من وجوه
العلاقة مع الغير، القريب و البعيد الذين يمثل الصديق و الغريب نموذجين
لهما، فما المقصود بالصداقة و هل يمكن أن تقوم علاقات اجتماعية أساسها
الصداقة ؟ و إذا كانت الغرابة تمثل أحد أوجه العلاقة مع الغير، فمن هو
الغريب و أي نوع من العلاقة يمكن إقامتها معه ؟
إن الصداقة تمثل نموذجا إيجابيا للعلاقة مع الغير و الصداقة لغة اسم مشتق
من الصدق الذي يعني الحقيقة و القوة و الكمال، و الصداقة في الواقع هي
علاقة حب و ود صادقين تنشأ بين إنسانين، إذا كان الحب عاطفة تنشأ عن ميل و
رغبة في الموضوع أو الشيء المحبوب و التعلق الشديد به، لكونه يشبع ذلك
الميل و الرغبة فأي نوع من الميول و الرغبات هي الصداقة ؟ و ما الذي يجعل
الصديق محبوبا و مرغوبا فيه و لماذا يرتبط الأنا و الغير برباط الصداقة ؟
هل نصادق الصديق لأنه شبيهنا أم لأنه ضدنا ؟ هل هو غاية في ذاته أم أنه
مجرد وسيلة ؟.
لقد فحص أفلاطون كل هذه الاحتمالات في محاورة "ليزيس" و التي خصصها لبحث
موضوع الصداقة و الخلاصة التي انتهى إليها هي أن الصداقة حالة وجودية تمثل
علاقة حب متبادلة أساسها حالة وسط بين الكمال المطلق و النقص المطلق، بين
الخير الأقصى و الشر الأقصى، لأن من يتصف بهذين الصفتين إما لأنه مكتف
بذاته، فلا يحتاج إلى الغير، أو تنعدم لديه كل رغبة في طلب الخير أو الكمال
و لذلك فإن الصديق هو من يتصف بقدر كاف من الخير يدفعه إلى طلب خير أسمى و
يتصف بقدر من النقص لا يحول بينه و بين البحث أو الكمال، فكلا الطرفين
يبحث في الآخر عما يكمل نقصه.
أما الصداقة كتجربة معيشة و حالة واقعية فقد بحثها أرسطو و وجد أنها تنقسم
إلى 3 أنواع: صداقة المتعة و المنفعة و الفضيلة، النوعان الأولان متغيران
لأنهما يوجـدان بوجود المتعة و المنفعة و يزولان بزوالها، و لهذا لا
يستحقان اسم الصداقة بمعناها الحقيقي، أما الصداقة الحقة فهي صداقة الفضيلة
لأنها تقوم على محبة الخيـر و الجمال لذاته أولا ثم للأصدقاء ثـانية، لذلك
تـدوم و تبقـى، و خلالها تتحقق المتعة و المنفعة كنتيجتين لها، لكن هل
يمكن قيام مجتمع على الصداقة، إن هذا يفترض أن يكون مؤلفا من أقارب فقط أي
مجتمعا صغيرا كالأسرة أو العشيرة أو دولة مجتمع المدينة اليونانية حيث لا
يوجد الغير البعيد أو الغريب و إن وجد فهو معزول و لا يمكن أن يندمج في جسم
المجتمع فالغير الغريب الحقيقي بالنسبة لهذا المجتمع هو المجتمعات
المختلفة ثقافيا أو دينيا أو عـرقيا و التي تعتبر أعداء أو خصوما، أما في
المجتمع الكبير و المنفتح على المجتمعات الأخرى فإن دائرة الصداقة و مجالها
يكون محدودا وسط خضم الأغيار، إن الغير الغريب في هذه المجتمعات يتحدد
باعتباره ذلك المجهول أو الغير مألوف أو الغامض أو المخيف أو المهمش، أما
في إطار العلاقات الاجتماعية الملموسة فإن الغريب يتحدد باعتباره كل من
يتطفل على جماعة بشرية منظمة متماسكة أو يرفضها محدثا في جميع الحالات خللا
و عدم توازن في الجماعة، فتتجه هذه الأخيرة إلى تدميره أو إقصائه أو
تهميشه لمحاولة استعادة توازنها و استقرارها.
غير أن وحدة الجماعة ليست في الحقيقة سوى مظهر عام، و عندما نبحث في طبيعة
هذه المادة يتضح لنا أن الجماعة تحمل في ذاتها بحكم اختلافاتها و تناقضاتها
الذاتية الداخلية غريبها الخاصة قبل أن يدخل إليها غريب أجنبي، و هذا ما
عبرت عنه كريستيفا بقولها " إن الغريب يسكننا على نحو غريب".
و إذا كان الأمر كذلك فإن الموقف الطبيعي الذي ينبغي اتخاذه من الغير
البعيد (المهاجر –الأجنبي –الجنس الآخر –المجتمع الآخر) ليس هو موقف النبذ و
الإقصاء و العداء و الحرب، بل موقف التسامح و الاحترام أولا، لأنه أنا آخر
كائن بشري مثلنا، و ثانيا لأن الوجود البشري فرديا كان أو جماعيا هو نقص و
نداء للغير من أجل تجاوز هذا النقص و يؤكد ليفي ستراوس أن الحوار بين
الأنا و الغير يتطلب أن يحتفظ كل منهما باستقلاليته و هويته.